صراع الذاكرة: كيف نصنع عدالة السرد لثمانينيات السجون السورية؟
بقلم نوَار جبور
November 11, 2025
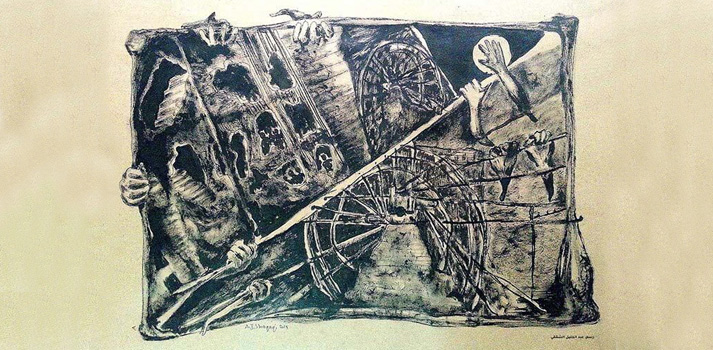
اللوحة بريشة عبد الجليل الشققي
تشكّل كلمة «الثمانينيات» في المخيال السوري أحد أبرز أشكال الذعر اللغوي؛ فهي لا تدل على مجرّد عقدٍ زمني، بل تشير إلى لحظة بدأ فيها سجنُ المجتمع بأكمله. في تلك الحقبة، أُعيد تشكيل الدولة السورية كجهازٍ للخوف عبر اعتقال معظم الساسة والنقابيين والكُتّاب، مع تصاعد الصراع داخل السلطة بين حافظ ورفعت الأسد عام 1984. كان الخلاف بينهما قائمًا على خلفيةِ تحويل السوريين إلى أحياءِ الضرورة، لا يطلبون سوى البقاء، بعد سحق القوى اليسارية والعروبية والإسلامية وسحق السياسة، وتجريد المجتمع من القدرة على المقاومة، في مقابل تضخيم الدور الإقليمي لسوريا بتعطيل السياسة داخليًا. وكان هناك تمايزٌ حاد ذا صبغةٍ أهلية في التعامل مع السجناء الإسلاميين منذ الستينيات وصولًا إلى الثمانينيات.
يبدأ القوس فعليًا أواخر السبعينيات مع تضييقٍ سياسي واحتقانٍ اجتماعي. في هذا المناخ ظهر التجمّعُ الوطنيّ الديمقراطي محاولةً مبكرة لإعادة السياسة إلى العلن من خارج مظلّة البعث. تأسّس أواخر 1979/كانون الثاني/يناير 1980 كائتلافٍ معارض «موازٍ» للجبهة الوطنية التقدّمية، ضمّ خمسة أحزاب يسارية وقومية/ناصرية: الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، حزب الشعب الديمقراطي السوري (جناح رياض الترك، الشيوعي ـ المكتب السياسي سابقًا)، حزب العمال الثوري العربي، حركة الاشتراكيين العرب، وحزب البعث الديمقراطي العربي الاشتراكي (تيار صلاح جديد). هذا المناخ السلمي دفعته السلطة بسرعة نحو لحظة شباط 1982 ومجزرة حماة، ثم تُرجم لاحقًا في صراع الأخوين عام 1984 بوصفه إدارة داخلية للخوف بعد تعميمه اجتماعيًا.
بلغ العنف ذروته في مجازر حماة عام 1982 حيث سُحقت المدينة وذاكرتها. بالتوازي، اندلعت مواجهاتٌ منخفضة الحدة في مدن وبلدات متفرقة، ضد مجتمعات محلية وإسلاميين مسلّحين، ترافقت مع اغتيالات واشتباكات ومحاولات تمرُّد محدودة، واجهها النظام باعتقالات وضربات أمنية متكرّرة. ومنذ 1963، ترسّخ شكلٌ من الخوف التعليمي/المحاكاتي جعل الأفراد يديرون تفاصيل حياتهم اليومية بناءً على احتمال الاعتقال، عبر تحكم شديد في اللباس، الكلام والعلاقات.
غالبًا ما يُستدل على مجازر تلك المرحلة بكلمة «الأحداث»، فيما تحوّلت الثمانينيات إلى مقبرةٍ للمعنى، وإلى نقطة تصعيد لغوي كثيف. بدأت السياسة تُدار عبر مصطلحات تؤطِّر الواقع دون تسميته: «إسلاميون متطرفون»، «بعثيون تقدميون»، «علمانيون متأسلمون»؛ أدوات خطابية سمحت للنظام بتجنب تسمية العنف والاحتماء باللغة. وهكذا أصبحت كلمة «الثمانينيات» أكثر من دالّ زمني، بل مختصرًا لحالة قمعٍ شامل، ولزمن لم يعد للإنسان فيه معنى سوى أن يكون ذائبًا ومقموعًا. ارتبط هذا العقد ببُنية الخوف التي جسّدتها السجون الكبرى، فغدا «الملفُ» ذاكرةً أمنية باردة لا تحتاج إلى رصاص لتعمل.
وفق رولان بارت، تتحوّل الكلمات اليومية إلى أساطير سياسية حين تتجاوز معناها المباشر وتكتسب وظيفةً رمزية داخل الخطاب العام. بمعادلة قريبة تحوّلت الثمانينيات إلى ميثولوجيم. أقصد بــميثولوجيم هنا كلمةً أو صورة خرجت من معناها المباشر وصارت تعمل كـ«أسطورة-علامة» داخل الخطاب العام؛ وفق دلالة من درجة ثانية تصبغُ الواقع بمعنى مسبق. لا نصف السنوات من 1980 إلى 1989 حين نقول «الثمانينيات»، بل نستدعي شبكة إيحاءات: السجن، الخوف، تعطيل السياسة، واقتصاد الصمت. بهذا المعنى تصبح الكلمة أداةً لتنظيم الذاكرة والسلوك أكثر مما هي توصيف زمني بريء. هكذا تغدو رمزًا مكتنزًا بالرهبة يختصر جحيم السجون والمجازر ويمحو الحدّ الفاصل بين الواقع ومحاكاته. تحولت الكلمة نفسها إلى أداة تعليمية داخل العائلة السورية، تمنع الفعلَ وتدفع نحو الصمت، وتثبّت في الوعي الجمعي أنَّ ضرورات العيش وحدها ما يمكن السعي إليه. في التسعينيات اختفى كلّ أثرٍ للعنف عن الساحة العامة والسياسية مع ترسّخ سلطة حافظ الأسد؛ فقد تحوّلت أسطورة الثمانينيات إلى متخيّلٍ مُغلق، وانبثق طورٌ جديد من آليات الضبط السورية للنفس. لم يعد شيءٌ في دائرة الحيّز العام أو الفعل السياسي، حتى بعد انتقال السلطة إلى بشار الأسد. في المقابل، خرج آلاف المعتقلين من السجون، لكنّ سردياتهم الطويلة عن تدمر وصيدنايا وآلام الاعتقال ذهبت أدراج الرياح، طُمست أو أُدرجت في طيّ الصمت، باستثناء محاولات قليلة جديرة بالذكر مثل عمل مؤسسة «أمم للتوثيق والأبحاث» اللبنانية على توثيق سجناء الثمانينيات وسجون تدمر وغيرها. فيلم «تدمر» (مونيكا بورغمان ولقمان سليم) جمعَ شهادات معتقلي الثمانينيات عن الرعب والذل اللي عاشوه جوّا المعتقل. رواية «القوقعة» لـمصطفى خليفة كُتبت من قلب سجن تدمر، وقدَّمت السجن كعالم مغلق يكسر الروح قبل الجسد.
منصة «الذاكرة الإبداعية للثورة السورية» نشرت قصص معتقلين وأبناء معتقلين رجعوا يحكوا عن أثر الثمانينيات في البيوت والذاكرة.
هاي الأعمال ما وثّقت بَس الماضي، بل رجّعت الثمانينيات كحقيقة لسَا عم تشتغل بالحاضر.
تحوّل الخوف في الثمانينيات إلى ما يشبه الغريزة الاجتماعية. لم يعد العنف مجرد حدث خارجي، بل ترسّب في الجسد واللغة والعلاقات. تصف فينا داس هذا التحوّل بأنه استقرارُ العنف في الحياة اليومية.
ترسّخت في الثمانينيات بنى لغوية ثنائية قسّمت المجتمع وأطفأت السياسة. رُوِِّجت ثنائية النظام/الفوضى، بينما ظلّ الهيكل الأعمق، الدولة/الخطر، يحكم توزيع المعنى ومن يُسمَع ومن يُسكَت. عاش السوريون داخل نطاق كلمة صارت قالبًا للعيش لا مرآة له؛ فـ«الثمانينيات» لم تعد دالًا زمنيًا بل صيغة تدير الحياة اليومية وتنسج العلاقات. قاموسها الإداري: «الأحداث» و«الملف» و«العناصر» ــ أعاد تسمية المجزرة حدثًا، والإنسان رقمًا، والجلاد وظيفة، فاختُزلت الوقائع ونُفيت بدائل السرد. جرى ذلك على أجساد المعتقلين، وعلى حساب أحزاب كانت تحاول صياغة خطاب عام والتموضع داخل مجال سياسي أُفرغ قصْديًا من مضمونه.
ماذا بعد النسيان؟
منذ الثمانينيات حتى 2011، حُدِّد بدقّة ما يمكن سردُه وما يجب دفنه. لم يكن القمع مجرد أدوات أمنية، بل مشروعًا لغويًا ذا طابع نِسياني مُنظَّم. لم يكن الفقدُ حياتيًا فحسب بالنسبة إلى آلاف المعتقلين والمقتولين، بل سُحب منهم أيضًا حقُّ التمثُّل في المجال الاجتماعي، وجُرِّدوا من شرعية الوجود الرمزي. لم يكن النسيان نتاجَ تقادمٍ زمني، بل مسارًا مؤسَّسًا، بيولوجيَّ الطابع، يُجهِض آليات التذكّر من جذورها. لم تطمس السلطة السورية الأحداث فحسب، بل رسمت نمطًا معرفيًا يُجرِّم الذاكرة ويكافئ الغفلة. جيل الثمانينيات أُعيد تعريفه قسرًا: إمّا منفيَاَ، أو خاسرًا في حرب أهلية فاشلة، أو ببساطة غير مذكور.
ثم كانت 2011؛ لم تفتح جراحًا جديدة فحسب، بل نبشت طبقاتِ جراحٍ طُمست عمدًا تحت ركام «النسيان المفروض». تحوّلت الثورة إلى نقطة انقطاع معرفي قلبت آليات النسيان، وأعادت صياغة الذاكرة السورية لا كهويّة وطنية، بل كهويّة معذّبين واعين؛ ذاكرة تتأسس لا على ما حدث فحسب، بل على إدراكٍ عميق لكيف مُنع من الحدوث سرديًا. لم تفتح الثورة السجون فقط، بل فتحت معها خزان الصمت؛ صمتٌ لم يكن غيابًا للكلام، بل منظومةً قمعية من اللا-قول واللا-تسمية والطيّ الرمزي. كان 2011 فأسًا حَفرت في التربة الصلبة لذاكرةٍ مدفونة منذ الثمانينيات؛ حقبة لم تُحْكَ، بل اختنقت في الزنازين، واختُزلت في مشاريع صغيرة لمساندة التذكّر، ثم زُرع فوقها مجددًا ما يمكن تسميته بـ«النسيان المفروض»؛ نسيانٍ لا ينبتُ من الإرهاق، بل يُزرع كسياسة.
ومع انفجار الخزان، تحوّل الرعب من ممارسة خفية إلى مادةٍ استعراضية يُعاد تدويرها؛ صار تدفّق الصور لا يصنع ذاكرةً بل يراكم بَلادةً إدراكية. لم يعد المجتمع يُصاب بالصدمة من الصور، بل بفقدان القدرة على إدراكها أصلًا. تشبَّعت الحواس حتى الخرس. هنا يظهر شكلٌ جديد من الذاكرة: جيلٌ لا يتذكّر ما لم يعشْه فقط، بل أيضًا ما لم يُرْوَ له أصلًا. لم تعد الذاكرة حنينًا ولا معنى، بل ميراثًا مثقّلًا بعجز التمثيل وهشاشة الاستيعاب. ورث هذا الجيل الحدث كندبةٍ بلا جرح، كرعبٍ دون مشهد واضح؛ وهذا أخطر الإرث: أنْ ترث كيف تمّ نسيانُ ما حدث، لا الحدثَ وحده.
ومع الطوفان البصري واللغوي وتشردِ ملايين السوريين خارج البلاد، تراجعت صور عنفِ الثمانينيات إلى منطقةٍ صامتة في الوعي الجمعي؛ نسيانٌ داخل نسيان. النسيان لا يحدث فقط حين نكفّ عن التذكّر، بل حين يبتلع الحاضرُ الماضيَ بمعناه، فينقطع التسلسلُ السردي والأخلاقي للتاريخ. وهكذا لم يُمحَ معتقلو الثمانينيات لأنَّ أحدًا أنكرَهم، بل لأنَّ كثافةَ المأساة الجديدة جعلت تذكّرهم فعلًا غير ممكن أو بلا جدوى. بين الجيلين خيطٌ مشترك: لم ينجُ أحد، لم يتكلم أحد؛ حمل الكُل صمتًا أكبر من طاقته. وما نعيشه اليوم ليس استمرارًا للعنف فقط، بل استمرارًا لنفي هذا العنف.
يمكن فهم امتداد «الثمانينيات» بتفكيك الزمن على طريقة بروديل إلى المدى الطويل والدورات المتوسطة والحدث السريع: في المدى الطويل ترقد بُنى تكاد لا تُرى؛ الدولةُ كهواءٍ يومي، جهاز أمني صنع خرابًا ممتدًا، ومدرسةٌ وتربيةٌ ومراكز دينية تضبط القاموس والسلوك. وفوقها تدور دوراتٌ متوسطة تُعيد ضبط السلطة (مثل صراع الأخوين ومجزرة حماة ضمن سلسلة أوسع). وضمن هذا الإطار يمكن إدراج 2011 كـ«حدث سريع» كشفَ طبقاتٍ قديمة ثم تمدَّد إلى «دورة متوسطة» أعادت ترتيب المشهد. هكذا نفهم أن «الثمانينيات» ليست تاريخًا فحسب، بل قالب عيشٍ لغوي نظّم اليومي وعلاقات الناس، من دون أن نسمح للحدث السريع أن يبتلع البُنى التي سبقته.
شيءٌ من منظومة ما بعد 2011 شكّل شبكة معتقدات وسياقات أعادت ترتيب السرد العام؛ فمَالت الذاكرة إلى معيار قسوة جديد، وتراجعت الثمانينيات إلى الهامش لا بوصفها منفية فحسب، بل لأن شروط التذكّر العمومي أُعيدَت صياغتها لصالح الراهن. سقوطُ نظام الأسد لم يُعِد تكريس سرديةٍ عبر الناس أو عبر فكرة الحقوق والتعويض. بقيت «الثمانينيات» دالًا ثقافيًا عالقًا بلا اعتراف، فيما انطلقت السلطة الجديدة من 2011 كدالٍّ حصري لسردية النضال. صار لأرشيف الثمانينيات بعدٌ أرشيفيّ لا وظيفيّ، وتحولت الكلمة إلى دالٍّ مُربِك يُفرَّغ ويُستبدَل على نحوٍ قطعي. ليست المسألة تنازعَ سرديتين، بل ضرورة الاعتراف بالأحياء والناجين من تجربة السجون التي بدأت في الثمانينيات وانتهت إلى صيدنايا وتوسعاته والمقابر الجماعية.
هناك ميزة تاريخية أيضًا: الثمانينيات تُعبّر عن مشترك سياسي حقيقي؛ معتقلون من كل الطوائف والتيارات ـ يساريون وعروبيون وإسلاميون ونقابيون وكُتّاب. كان يمكن لهذا المشترك أنْ يكون حجر الأساس لذاكرة وطنية جامعة. لكنَّ السلطة الجديدة فضّلت ذاكرةً وظيفية تُدير الحاضر بدل أنْ تُصالحه مع ماضيه؛ فاستُبدلت رواية التعذيب والسجون الجماعية برواية حرب 2011 وحدها، وكأن ما قبلها مادةٌ خام للتاريخ الشفهي لا للتاريخ العام. بهذه الحركة، مُحيَت «الخبرةُ الجامعة» التي حملها سجناء الثمانينيات. لم يعودوا مؤسِّسين لمعنى المُواطنة المعارضة، بل ضيوفًا غير مرحَّب بهم على سردية انتصار تريد أبطالًا مطابقين لذوْق المرحلة. لم يُكرَّموا، لم تُصَغ شهاداتهم في سجل الدولة، ولم يُعترَف بمساهمتهم في حماية فكرة السياسة من الطائفية التي عمل النظام السابق على ترسيخها. النتيجة أنَّ ذاكرة السجن عادت إلى سجن الذاكرة.
لم تعد المسألة استدعاءَ الماضي بل كيفية توثيقه وأرشفته. منذ 2011 أُعيد ترتيب السرد العام عبر إدارةٍ للأدلة تُحوِّل الوقائع إلى ملفات وصور وجداول؛ فينتقل من حجّةٍ للحق إلى تقنيةٍ لضبط الأزمة. التوثيق والأرشفة ـ بدل أن يفتحا باب المساءلة ـ قنَّنا الذاكرة وأغلقاها داخل تصنيفات محايدة تُطفئ اللغة الأخلاقية وتستبدلُها بلغة الإجراء. هكذا تآكلت الحقوق لأنَّ معيار الإدراج في الأرشيف حلّ محل معيار العدالة، وغدا النضالُ السياسي ملحقًا إداريًا لاقتصاد الصورة والمنصّة. وفي الحيّز العيني توسّعت فضاءاتُ السيطرة أفقيًا وعموديًا حتى صار الموت بُنيةَ تنظيمٍ للفضاء العام، معيارًا للحركة والسكوت والمرئي والمستور. ومع هذا الاتساع تراجعت ذاكرة الثمانينيات لأنها لا تنافس اتساعَ «سياسة الموت» الراهنة ولا سرعتها؛ تُستدعى كفهرس بلا مطلب، كوثيقة بلا دعوى. هكذا يصبح الأرشيف نفسه أداة نسيان منظّم: يظهر فيه كل شيء ولا يُعترف فيه بشيء.
كلُّ نسيانٍ وإخفاءٍ في الحيّز العام لمعتقلي السياسة ـ الذين افتُتِحت السجون على أجسادهم ـ هو تثبيتٌ لذاكرةٍ مصنوعةٍ على مقاس السلطة الجديدة. واستعادةُ السياسة، وتكريسُ المتَْحفيّة السجْنية، وإعادةُ الاعتبار للخطاب السياسي، لا تكون إلا بإصلاح شروط المعرفة العمومية: تسميةٌ دقيقة لا تلطيف فيها، أرشيفٌ مفتوح يحفظ لا يُخدِّر، ومسارُ محاسبةٍ يعيد الاسمَ إلى الجسد والواقعةَ إلى سياقها. الذاكرةُ بناؤها تقاطعيٌّ وتركيبيّ، وهي مخياليّة أيضًا لا استرجاعُ صورٍ فحسب. لا نحتاج من الثمانينيات ولا من سرديّات الموت بعد 2011 محاكاةً أو سببًا يبرّر الحفظ، بل أنْ نعرف كيف نخرج من التلفيق و«إعادة التعلّم» القسري، من أجل حماية المرْويات بوصفها خبراتٍ معاشة علينا نقدُها والتحذيرُ من وجوهها المُضلِّلة. المشكلة أنّ بعض مَن يتذكّر يريد لذاكرته ألا تعرف: أن تبقى سرديّةً تؤكّد الذات ولا تفسح مجالًا للفهم. الفهم هنا إفادةٌ معرفيّة: التذكّر ممارسةٌ معرفيّة، لا صورةٌ حسّية قابلةٌ للاستدعاء فحسب؛ تخييليٌّ نعم، لكن مضبوطٌ بمعايير الموثوقيّة كي ينتج معرفةً تُحاسِب، لا إعادةَ تلفيق. لقد فرح الكثيرون من معتقلي الثمانينيات والذين خرج بعض منهم في بداية الألفين لسقوط نظام الأسد، إلا أنهم لم يحصلوا على أي اعتراف، ولم يُسمح لهم حتى بإعادة بناء أحزابهم التي جعلتهم معتقلين ومغيبين لسنين طويلة.
لا بدّ من مشروع وطني سوري للعدالة، لا يقتصر على المساءلة القانونية، بل ينطوي على هامش رمزي واسع لتبادل الاعتراف، خاصة بجيل الثمانينيات، باعتباره الحجر الأساس للمواجهة المبكرة مع الاستبداد، ولَبنةً أساسية في التاريخ السياسي المقاوِم.
يجب أنْ يتجسد هذا الاعتراف في المناهج العامة للدولة، وفي المجال العام، لا باعتبارهم رموزًا عابرة، بل كفاعلين في صنع الوعي السياسي، وكشهود على لحظة حاول النظام طمسَها من سردية الوطن.
وعلى هذا الأساس، لا يمكن التعامل مع التذكّر كحنينٍ فردي أو تمرين سردي، بل بوصفه كيانًا احتماليًا، أي مساحة مفتوحة للكل، تُمكّن المجتمع من اختيار ذاكرته وإعادة بنائها بما يضمن الاعتراف المتبادل وتحرير التاريخ من السلطة المطلقة في تعريفه.
المشكلة في سوريا اليوم أن ما يتبقى ويعيش ويُسرد هو العقاب والقسوة، لا الاعتراف الاجتماعي بما عاشه السوريون. أحد أشكال الاعتراف الأهم هو ما يطرحه أمارتيا سن، في تفريقه بين القصاص والإنصاف، باعتبار العدالة مشروطة بمشاركة الجميع، لا فقط في المحاسبة، بل أيضًا في السرد. العدالة لا تبدأ من المحكمة، بل من القدرة على الحكي، من جعل الذاكرة مساحةً عامة ليست حكرًا على أحد.
نوار جبور كاتب وباحث سوري، يعمل في مؤسسة لقمان سليم، على الشأن اللبناني والسوري. يدرس الفلسفة في جامعة القديس يوسف بيروت. يعمل في الكتابة والصحافة منذ عام 2011 نشر بأسماء مستعارة لأكثر من عشرة سنين خوفًا من الملاحقة الأمنية.