١٤ شباط، ٢٠٢٢
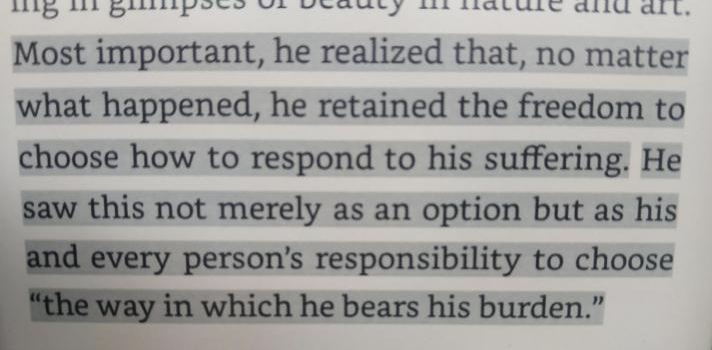
«الصَّدمة هي الطَّـورُ الأول لـردود الأفعال العقلية. حيـنما يتفـحَّـصُ الإنسان القدرَ الهائل من المادةِ التي تكـوَّمتْ نـتيجةً لمُلاحظاتٍ كثيرة عن المَسجونين وخبراتهم، تـتَّـضِحُ أطوارٌ ثلاثةٌ تمر بها ردودُ الأفعال العقلية لدى النَّـزيلِ حيال حياة السِّجن: المُعسكَر، الفترة التي تعقبُ إدخاله السجن مباشرة، والفـترة التي يكون فيها قدِ اندمجَ تمامًا في نظام المعسكر، ثم الفـترة التي تعقبُ إطلاقَ سراحه وتحـرُّره».
فكـتور فرانـكل، صاحـب كتاب «الإنـسان يَـبحث عن المعنى»
بعد أن صفـعَني العقيدُ نائبُ رئيس فرع سعسع، «الجـبـهة»، بعبارة «أنتَ ضيفـنا»، ضربَ زرَّ الجرس المَرمِيَّ على طاولـته باسترخاءٍ مُستـفِز. فـتح البابَ عسكريٌّ صلفُ الطِّـباع خَشِنُ الملامح، خبطَ الأرضَ بـقدمه اليُمـنى بلبطةٍ مُدوِّية رافقَـتها صرخةٌ: «أمركَ سيدي». أمرَه العقيدُ بأخذِي إلى السِّجن، فما تأخَّـر العسكري ثانـية. إذًا، هو الاعتقال الذي قال عنه صاحبُ كتاب أرخبيل الغولاك، ألكسندر سولجنيتسين، بأنه «تحطيمٌ لحيواتنا كاملةً. أو هو صاعقةُ بَـرقٍ مباشرة تقطعُ أوصالَنا، أو هو زلزالٌ نَفسِيٌّ كاسحٌ يَجـتاح الجميع، وغالبًا ما يَخِـرُّ مَن لم يستطع الصمودَ أمامه زاحفًا، فاقدَ العقل والجنان. الاعتـقالُ هو القذفُ اللَّحظِيُّ الصاعق، هو الرَّمي، والانقلاب من حالةٍ إلى أخرى. إذًا، هو الاعتـقال، شرارةٌ تَصعقُك، وصدمةٌ تَـأتيك من الماضي بـشَدِّكَ إليه أبدًا، دون أن يَـتحرَّك إلى الأمام مرةً واحدة، لا يُمكنكم الاستيعاب... لا في الساعة الأولى ولا في اليوم الأول».
يَومها لم أُدرِكْ أنَّ تلك اللحظةَ ستُـغيِّر حياتي كُلـيًّا.
سِجنُ توقيـفِ فرع سعسع عبارةٌ عن بناءٍ حقير، فوق الأرض، مُلحَقٌ بمكاتبِ التحقيق. سلَّـمني العسكريُّ بـزَهوٍ إلى سَجانٍ قصيرِ القامة يتحرَّكُ ويتكلَّم كديكٍ بلديٍّ مُلـوَّن. تأمَّـلَني الأخيرُ بقَرفٍ من رأسي حتى قدمي، قبل أن يَأمرني بالتعرِّي الكامل. لم أفهم مُرادَه فخلعتُ ثيابي مُبقِـيًا الداخلِـي منها. أشار بعَصاه إلى لباسي الداخلي، مؤكدًا وجوب خَلـعه. فعلتُ ما طلب، تابعَـني بعيونه، مُلحِقًا أمرَه باتِّـخاذ وضعية القرفصاء ثم الوقوف ثلاث مرات. كان خلالها يُفـتِّش ثِـيابي ويَنـتزع منها المحفظة والحزام، ورباط الحذاء، ثم أخذ نَظارتي الطِّبية. جمعَهم في كيس نايلون وربطَه قبل أن يَـزجَّه في دُرجِ مكتـبه الحديدي. أمرَني بارتداء ثيابي، وهو يُدوِّن اسمي في سجلٍّ كبير مُجدوَل، مُرفَـقًا بالتاريخ وملاحظةٍ عن ماهية «أماناتـي».
فتحَ بابَ السِّجن المُطـلَّ على غرفـته الصغيرة، قلم السّجن، ثم جـرَّني من يدي إلى المنفردة الثامنة. دفعَـني في عتمة المساحة التي لا تـتجاوز المترين بـمِتر. رائحتُها لا تُحتمَل، بطانية عسكرية يتيمة غارقة بـبرازِ وبولِ مَن سبقوني إلى هذه العتمة. جمعتُ البطانيةَ في زاوية المنفردة قبل أن أَفـترِشَ معطفي تحتي وأنام. استيقظتُ بعد ساعاتٍ طويلة على صوت «حسن»، زميلي الذي اعتُـقِلَ لاحقًا في ذات اليوم بـتُهمة تزويدي بأوراقٍ مُصوَّرةٍ من كتاب «الشلاح». دفعَـني «حسن» لـتَناول سندويتش الفلافل، الوجبة اليتيمة في هذا الفرع، فرفضتُ وعدتُ إلى النوم. بقيتُ، دون قصدٍ أو وعي، لـثلاثةِ أيامٍ بلا طعام، أصحوا من نومي للخروج إلى الحمام، فأتبولُ وأشربُ بعضَ الماء وأعودُ للنوم ثانية. كان النومُ سلاحي للهروب من الاعتـقال الذي تراكمَ في ذهـني. اكتشفتُ لاحقًا أنه تراكمَ في أذهان أصدقائي وأهلي، وجيراني في قرية «الحرية» التي كنتُ قد استأجرتُ بيـتًا فيها كي لا أقطع المسافةَ الطويلة بين معهد الدِّراسة وسَكنِ عائلـتي في جبال القلمون.
(لا تَستـغرِبوا، هناك قريةٌ في سهول الجولان السوري «المُحـرَّر» اسمها «الحرية»)
رغم المسافة، إلا أنَّ اعتـقالي تراكمَ في أذهان مَنْ عرفَـني في مدينتي الصغيرة «جيرود». الاعتقال في سورية، رائحةٌ فريدة تَـنقـلُها رياحُ الهمَسات المكتومة الخائفة مِنْ تَشابُـهِ المصير. الاعتقال بوابةُ السِّجن الصغير، يَخرجُ السوريُّ مِنْ سجـنه الكبير لـيَدخُلَ سراديبَ الغياب والنسيان الكلي. لذا يكسي الناسُ اعتـقالَ معارفـهم بلَحمِ التفاصيل والحكايات والإشاعات، فيَستحيل الاعتـقالُ مع الوقت إطارًا شديدَ الفَرادة لأسطورةِ ذاك الذي «شحطَ إلى بيت خالـته»، المُسمَّى الأكثر شعبيةً لسجون المخابرات السورية. هكذا يُولَد الرعبُ ويُرهِـب النظامُ مجـتمعًا بأَسره، نعَم يُرهِــبه، مَن رأى عيون مُدرِّسي المعهد الذي كنتُ فيه يوم عدتُ إليهم بعد عامين كيف بَـدَت.. يُدرِك قصدي. مَن رصدَ الخوف المُستـفحل في عيون أصدقائي يوم جاءوا لـيُلـقوا عليَّ التحيةَ بعد خروجي من السجن.. يُدرِك هذا الإرهابَ جيدًا.
في التاسعَ عشر من آذار/مارس عام ٢٠٠٢، لم أكن قد سمعتُ أو عرفتُ الدكتور فكتور فرانكل، وتجربـته السِّجنية وتحليله العظيم لهذه المُعاناة. لم أُدرِكْ أنَّ سلوكي يومها كان طبيعيًّا بالنسبة لإنسانٍ يُحاوِل التَّـعاطي مع «الصدمة». اتخذتُ من النوم ميكانيـزم للدفاع عن نفسي؛ فكان الغيابُ سبيلي للهروب، تعبيرًا عن رفضي للواقع بكُلِّ ما فيه، برائحة البراز التي تعمُّ المنفردة، وأصوات التعذيب القادمة من غُـرَفِ التحقيق، وأسئلة أبـي الافـتراضية الكثيرة والتي تدور في رأسي بمَشهدٍ مُتخـيَّلٍ ليَومِ لقائنا بعد خروجي، إنْ خَرجتُ، حيث يُطالِـبني بتفسيرٍ لما جرى. أصدقُكم القول، كنت يومها خائـفًا من أبي أكثر من شعبة المخابرات العسكرية بكُلِّ ضُباطها ومُحقِّـقيها. أدركتُ يوم خرجت من السِّجن أنَّ خوفي كان بمَكانه، عندما صدمَـني بعبارته التي حُفِـرَتْ برأسي طويلًا: «لو ما كنت غلطان ما حبسوك». أبعدتُ غضبَ أبي عن رأسي بالنوم... أبعدتُ خوفي من العذاب القادم بالنَّـوم... أبعدتُ بالنوم صدمَـتي ببلادٍ افـترَضنا جميعًا أنها تتغير. كان النومُ سلاحي للحفاظ على عقلي وتوازني؛ بالطبع هذا ما فهمـتُه لاحقًا... لا ما أدركـتُه حينها.
صباح يوم الخميس، ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، بعد ثلاثة أيامٍ منِ اعتـقالي و«حسن». فـتحَ السَّجانُ بابَ المنفردة صارِخًا بأوامر الاستعداد والتجهز. توقعتُ أنهم سوف يُطلِـقون سراحَـنا بعد أن دقَّـقوا بالمعلومات الغريبة التي وصلَـتهم في التقرير واكتشفوا براءتـنا. همستُ في سِرِّي، أنني سأكون مع جدتي في يوم عيد الأم، بحسب تقويم النِّظام السوري الموافق ليوم النيروز ٢١ آذار/مارس من كل عام. تابعتُ رسمَ الأمل: أنني سأصِلُ متأخرًا إلى بلدتي، في ريف دمشق على بعد ١٢٠ كلم، ولكنني سأكون معها في هذا اليوم كما وعدتُها. اتَّـكأتُ على الجدار المقابل لمكتب السَّجان، عند شعوري بالدوار. نظر السَّجانُ «الديك» إليَّ باحتـقارٍ شديد، ثم تناولَ عصا طويلةً من خلفه، «عصا مساحة»، وأخذ يصرخُ بوجهي: «أنت مُمثِّـل عظيم... أنت مُمثِّل بارع». لم أفهم سِرَّ غضبه، الذي تحوَّل إلى عنف. أمرني بمَدِّ يدي اليمنى كما يفعلُ الطلاب أمامَ مُدرِّسيهم في المدارس السورية. بالفعل، مددتُ يدي، فـهَوى عليها بالعصا. أمرني برفع اليسرى. تكرر المشهدُ كأنه مُقـتطَع من مدرستي الابتدائية. كثيرًا ما نالني هذا العقابُ في المدرسة لأسبابٍ مختلفة. يومها كنتُ تلميذًا كسولًا، تُـزيِّن الأصفار أوراقَ اختـباراتي، بالإملاء والرياضيات وكلِّ المواد الدراسية... ما عدا السلوك، كنت مُهذبًا أو هكذا كانوا يعتـقدون. كنت أُعاقَب كلَّ يومٍ في المدرسة، وأمام كل زملائي الذين لم يكن لي بينهم أي صديق. استردَّ رأسي تلك الصور المدرسية بدفقٍ جارف قبل سقوطي غائـبًا عن الوعي في غرفة «قلم السجن»، في فرع سعسع. يومها غبتُ عن الوعي نتيجةً لـقلة الطعام، لأصحو على ضرباتِ ذاتِ العصا فوق عنقي تُرافِـقُها المياه الباردة. صحوتُ غارقًا بالماء من رأسي حتى قدمي. أمرني المُحقِّـقُ الذي حضر سريعًا، بأكل سندويتش الفلافل مُتبِـعًا كلامه بعبارةٍ دبَّـتِ الرعبَ في أوصالي وقلبي: «يجب أن تأكلَ جيدًا، فـهناك... لا فرصةَ لهذا الدَّلال!» ... يُـتــبَــع.